
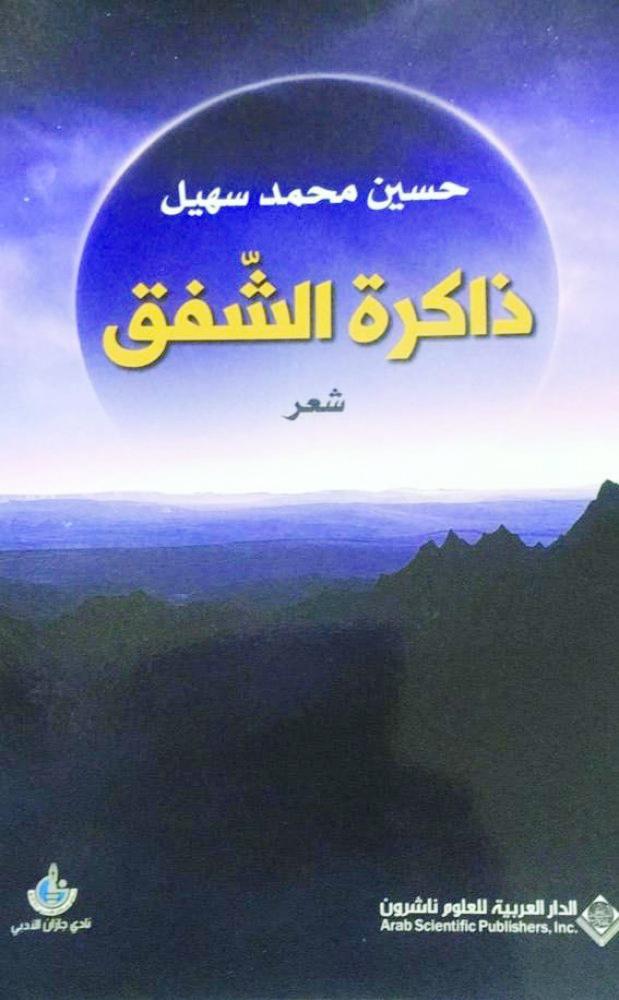
حينما قرأت ديوان صديقي الراحل حسين سهيل «ذاكرة الشفق» ـ ديوانه الذي وُلِدَ يومَ رحيله ـ رأيتُ الموتَ ساطعًا جليًّا في كلِّ نصٍّ فيه، بل في كلِّ مقطع..
نعم، إنني رأيتُ الموتَ يتنزّهُ متمهلًا من العنوانِ ابتداءً: «ذاكرةُ الشفق».. الشفق الذي يمنحُ دلالاتٍ عديدةً مثل الغروب، الرحيل، الذبول، الوداع، وانطفاءِ العمر..وما تلك الذاكرةُ التي أضافَها صديقُنا الشاعرُ الراحلُ إلى الشفق؟ ماذا تعني؟ وماذا تتمثّل؟..إنها تعني ـ فيما تعني ـ حشدًا من دلالاتِ الموتِ وصورهِ وغواياتِهِ.. ثم إن هذا العنوانَ الوجوديَّ العميقَ بحدِّ ذاته يصوغُ اختزالًا فادحًا لما أرادَ أن يبوحَ به الشاعرُ ويحكيهِ لنا عبر نصوصِ الديوانِ كلِّها.. كما لو أنه أرادَ أن يقولَ: حزمتُ حقائبي وهيّأتُ كفّي للوداعِ غيرِ الجميلِ.. يدعمُ هذه الدلالاتِ ـ التي كانت حاضرةً في العنوانِ الظاهرِ على الغلافِ الأولِ ـ نصٌّ مؤثرٌ جدًّا ورَدَ في الغلافِ الأخير..متحدّثًا فيه الشاعرُ عن انطفاءِ الزمن، عن سباتِ عقاربِ الساعة، عن النومِ الأبديِّ، عن أوانِ الموتِ، عن الموتِ الذي كان حسين سهيل يهجسُ به في جلِّ نصوص هذا الديوان..وكأنَّ الغلافين قوسان كبيران يضمّان فَنَاءً.. لنقرأ معًا ملمحًا من نصِّ «الساعة» الذي ورَدَ في الغلافِ الأخير:
«تدقُّ في الظلامْ
تعيدُني إلى الوراءِ
نصفَ ساعةٍ..
ونصفَ ساعةٍ، وعامْ
وقبلَ أن أديرَ وجهَها الجميلْ
عرَفْتُ أنَّ ساعتي
تغطُّ في سباتِها النبيلْ».
إن «الموتَ» في نصوص هذا الديوان يحضرُ كمفردةٍ مباشرةٍ صريحة: ( الموت / الردى / القبر...إلخ )، ويحضرُ أيضًا عبر مفرداتٍ ومشاهد موحية: ( الرحيل / الراحلين / اليباب / الغياب / الأطلال / الوداع / الرثاء...إلخ ).
وما دمتُ قد ذكرتُ مفردة «الرثاء» هنا، فدعوني أشيرُ إلى قصيدة «صِنْوُ الضياءِ» التي كتبها حسين في رثاء صديقه الشاعر يحيى عبده واصلي..هذه القصيدة أصابتني بالذهول..إنه لا يرثي صديقَه الشاعر يحيى واصلي فقط، بل يرثي فيها نفسَه أيضًا.. هكذا بكل جلاء الشعر ونضارة اللغة، كما لو أنّ أبا رياض يحتذي صوتَ أسلافنا الكبار ألا وهو مالك بن الريب حين رثى نفسه!
قالَ حبيبُنا حسين سهيل مخاطبًا يحيى واصلي:
«رثاؤكَ؟ أم يكونُ هنا رثائي؟
وموتُكَ؟ أم بداياتُ انتهائي؟
ويكملُ متحدّثًا عن صديقه الراحل كما لو أنه يتحدث عن نفسه، هكذا:
«بكتْكَ الأرضُ، والأشجارُ قالتْ:
مضى في زهوِهِ صِنْوُ الضياءِ»
«ستبقى أيّها الجسَدُ المسجّى
تراتيلَ السماءِ إلى السماءِ»..
أليستْ هذه الأبياتُ الثلاثةُ تدعونا إلى التساؤلِ هكذا: هل بوسعِ الإنسانِ / الشاعرِ أن يحدسَ بدنوِّ أجله؟ هل يدرك بداياتِ نهايته، ورحيلَه وحيدًا تاركًا الخلقَ والطبيعةَ في شغلٍ بالحديث عنه وتقريظه ومدحه؟
إن شاعرنا الراحلَ بدا في شغلٍ كبيرٍ بالسؤالِ عن موعد الرحيل، عن الموت، وهو السؤالُ الوجوديُّ الضخمُ الذي حارَ فيه الناسُ جميعًا.. حارَ فيه الشعراءُ والمفكرون والفلاسفةُ وذوو الرؤى الفارهة..طرحوه جميعًا ولم يعثرْ على الإجابةِ عنه أحد..هذا القلقُ الوجوديُّ المشروعُ الذي انتابَ هؤلاء، انتابَ صديقَنا حسين سهيل، فأطلقَ سؤالَه العميقَ العريضَ في أفقِ القصيدةِ وفي أفقِ الحياةِ ذاتِها..أطلقه كمن يطلقُ طائرًا في الأعالي وهو يعي جيدًا أنه لن يكونَ قادرًا على استعادته أبدًا وأنه لن يحصل منه على جواب..السؤال الكبير الذي أطلقه حسين هو: «كم تبقّى»؟..أي كم تبقّى من العمر؟ وكأنه يرى عن كثبٍ قربَ رحيله..
قال أبو رياض:
«مدَّ جسرا..
يتراءى الوقتَ أعوامًا..
ليالْ..
كم تبقّى؟
يا له هذا السؤالْ..
مثل مَنْ يثقبُ صدرا..
أتُرى الباقي سويعاتٍ..وشهرا؟
لستُ أدري..
لا، ولا غيري بهِ قد كانَ أدرى»..
****
المؤلم هنا في نص حسين إن «الثغرَ» ـ وهو المعادلُ الموضوعيُّ للحياة حيث أنقذ شهرزادَ من سيفِ شهريار في تلك الأسطورة الشهيرة ـ كونه يحملُ دلالاتٍ فاتنةً تحتفي بالحياة، بالكلام الرقيق والهمس الجميل والقصائد الناعمة وبوح العاشقين وما تفضي به القبل..أقولُ: المؤلم إن هذا الثغر يستحيل قبرًا بل يستحيل إعلانًا عن أنّ كل سنوات العمر التي «عاشها» الشاعرُ لم تكن «عيشًا»، لم تكن «حياةً»، إنما كان ذلك العمرُ محضَ موت.. قالِبًا التعبير المعتاد «عشتُ عمرًا» إلى «مِتُّ عمرًا».. هكذا:
«مدَّ جسرا..
كيف صار الآن كهفًا؟
كيف صار الثغرُ قبرا؟
لكأنّي مِتُّ عامًا،
وسنينًا،
مِتُّ عُمْرا»..
** وفي قصيدة أخرى يحتضنها هذا الديوان، يخاطب شاعرنا الراحل قرية القصار الجميلة التي أضحت أطلالًا بعد غياب سكانها عنها مؤكدًا بشكل قاطع على أن «العمر رحل» هو أيضًا وليس السكان فقط..هكذا:
رحلَ العمرُ يا قصاري، وقلبي
ـ من حنينٍ ـ يضمُّ عشقًا «قصارَه».
*******
لقد ظلَّ حسين سهيل في سياق نصوص ديوانه «ذاكرة الشفق» مشغوفًا بالحديث عن الرحيل والراحلين، والعبور والعابرين، وكأنه يرسّخُ فكرة أن هذه الدنيا ما هي إلا محطة سفر وأن الآخرة دارُ راحةٍ أبدية مؤكدًا أنه مهما طال بنا المكثُ فثمة سفرٌ وارتحالٌ وثمة غيابٌ طويلٌ عميق..
قال أبو رياض في كلام موجز مؤثر:
«أجلْ أيها العابرون / استريحوا..
هنا نبتةُ الريح ِ،
وجهُ الخرافةِ،
فحمُ اليبابْ..
هنا التيهُ شيءٌ يُسمّى الغيابْ
وشيءٌ يُسمّى العذابْ»..
** وفي مقاطع أخرى يتناول أبو رياض موت الأمكنة، وسيادة الوحشة، وانطفاء الشوارع، وموت الصوت البشري، وهيمنة السكون والصمت الذي يعوي، وغياب الناس، وسطوة الخوف، وبقايا بقايا الوجود، وصراخ العدم، وحضور الأشباح، وبقايا الظلال..وأن لا أحد.. لا أحد..سوى رائحة ترابٍ دقيقٍ هو رائحة تراب القبر ولا ريب..كل ذلك نستلهمه في هذه المقاطع الشعرية العميقة التي زلزلتني:
«تحسستُ وجهي / وجلدي / مكاني.
بقايا من الظلِّ لما تزلْ..
بقايا أواني..
ورائحةٌ لونها كالترابِ الدقيقِ
وصمتٌ له وحشةُ الراحلينَ
على»دكّةٍ«في سباتِ الزمانِ»..
وفي مقطع آخر يقول:
«يا وحشة الديارِ للديارْ
«مطفأةٌ هي الشوارعُ الكثارْ»
يعوي بليلها السكونُ،
يذبلُ النهارْ
الصوتُ ماتَ من هنا
يلتّفُ في الضحى انصهارْ».
ويقولُ أيضا في مقطع ثالث:
«ورحتُ أسائلُ من غادروا دارَهم
أسائلُ جدرانهم
والمكانَ المخيف
وما من أحدْ»
ويضيفُ مدركًا أنه يسيرُ وحيدًا إلى حتفِهِ، إلى حيث لا أحد..سوى حضور الظلام المخيف الكثيف والسبات الأبدي، هكذا:
«وقد جئتُ وحدي
لكيما أراني
وما من أحد
وما من أحد
غير هذا الظلامْ»..
** وأخيرًا أقول: كما تناول شاعرنا موت المكان، تناول أيضًا الموت في الزمان، حيث تتجمد حركة الزمن، وتتوقف عقاربُ الساعة عن اللهاث، ويسود الموت وذبول الحياة..هكذا في مقطع من أجمل المقاطع وأكثرها شاعريةً وشجنًا:
مدَّ جسرا..
دقّتِ الساعةُ فجرا
مرّةً..أو مرتينْ
لم يعُدْ يسمعُها..
صارتِ الساعةُ
ص خ ر ا....
* شاعر وصحافي سعودي
نعم، إنني رأيتُ الموتَ يتنزّهُ متمهلًا من العنوانِ ابتداءً: «ذاكرةُ الشفق».. الشفق الذي يمنحُ دلالاتٍ عديدةً مثل الغروب، الرحيل، الذبول، الوداع، وانطفاءِ العمر..وما تلك الذاكرةُ التي أضافَها صديقُنا الشاعرُ الراحلُ إلى الشفق؟ ماذا تعني؟ وماذا تتمثّل؟..إنها تعني ـ فيما تعني ـ حشدًا من دلالاتِ الموتِ وصورهِ وغواياتِهِ.. ثم إن هذا العنوانَ الوجوديَّ العميقَ بحدِّ ذاته يصوغُ اختزالًا فادحًا لما أرادَ أن يبوحَ به الشاعرُ ويحكيهِ لنا عبر نصوصِ الديوانِ كلِّها.. كما لو أنه أرادَ أن يقولَ: حزمتُ حقائبي وهيّأتُ كفّي للوداعِ غيرِ الجميلِ.. يدعمُ هذه الدلالاتِ ـ التي كانت حاضرةً في العنوانِ الظاهرِ على الغلافِ الأولِ ـ نصٌّ مؤثرٌ جدًّا ورَدَ في الغلافِ الأخير..متحدّثًا فيه الشاعرُ عن انطفاءِ الزمن، عن سباتِ عقاربِ الساعة، عن النومِ الأبديِّ، عن أوانِ الموتِ، عن الموتِ الذي كان حسين سهيل يهجسُ به في جلِّ نصوص هذا الديوان..وكأنَّ الغلافين قوسان كبيران يضمّان فَنَاءً.. لنقرأ معًا ملمحًا من نصِّ «الساعة» الذي ورَدَ في الغلافِ الأخير:
«تدقُّ في الظلامْ
تعيدُني إلى الوراءِ
نصفَ ساعةٍ..
ونصفَ ساعةٍ، وعامْ
وقبلَ أن أديرَ وجهَها الجميلْ
عرَفْتُ أنَّ ساعتي
تغطُّ في سباتِها النبيلْ».
إن «الموتَ» في نصوص هذا الديوان يحضرُ كمفردةٍ مباشرةٍ صريحة: ( الموت / الردى / القبر...إلخ )، ويحضرُ أيضًا عبر مفرداتٍ ومشاهد موحية: ( الرحيل / الراحلين / اليباب / الغياب / الأطلال / الوداع / الرثاء...إلخ ).
وما دمتُ قد ذكرتُ مفردة «الرثاء» هنا، فدعوني أشيرُ إلى قصيدة «صِنْوُ الضياءِ» التي كتبها حسين في رثاء صديقه الشاعر يحيى عبده واصلي..هذه القصيدة أصابتني بالذهول..إنه لا يرثي صديقَه الشاعر يحيى واصلي فقط، بل يرثي فيها نفسَه أيضًا.. هكذا بكل جلاء الشعر ونضارة اللغة، كما لو أنّ أبا رياض يحتذي صوتَ أسلافنا الكبار ألا وهو مالك بن الريب حين رثى نفسه!
قالَ حبيبُنا حسين سهيل مخاطبًا يحيى واصلي:
«رثاؤكَ؟ أم يكونُ هنا رثائي؟
وموتُكَ؟ أم بداياتُ انتهائي؟
ويكملُ متحدّثًا عن صديقه الراحل كما لو أنه يتحدث عن نفسه، هكذا:
«بكتْكَ الأرضُ، والأشجارُ قالتْ:
مضى في زهوِهِ صِنْوُ الضياءِ»
«ستبقى أيّها الجسَدُ المسجّى
تراتيلَ السماءِ إلى السماءِ»..
أليستْ هذه الأبياتُ الثلاثةُ تدعونا إلى التساؤلِ هكذا: هل بوسعِ الإنسانِ / الشاعرِ أن يحدسَ بدنوِّ أجله؟ هل يدرك بداياتِ نهايته، ورحيلَه وحيدًا تاركًا الخلقَ والطبيعةَ في شغلٍ بالحديث عنه وتقريظه ومدحه؟
إن شاعرنا الراحلَ بدا في شغلٍ كبيرٍ بالسؤالِ عن موعد الرحيل، عن الموت، وهو السؤالُ الوجوديُّ الضخمُ الذي حارَ فيه الناسُ جميعًا.. حارَ فيه الشعراءُ والمفكرون والفلاسفةُ وذوو الرؤى الفارهة..طرحوه جميعًا ولم يعثرْ على الإجابةِ عنه أحد..هذا القلقُ الوجوديُّ المشروعُ الذي انتابَ هؤلاء، انتابَ صديقَنا حسين سهيل، فأطلقَ سؤالَه العميقَ العريضَ في أفقِ القصيدةِ وفي أفقِ الحياةِ ذاتِها..أطلقه كمن يطلقُ طائرًا في الأعالي وهو يعي جيدًا أنه لن يكونَ قادرًا على استعادته أبدًا وأنه لن يحصل منه على جواب..السؤال الكبير الذي أطلقه حسين هو: «كم تبقّى»؟..أي كم تبقّى من العمر؟ وكأنه يرى عن كثبٍ قربَ رحيله..
قال أبو رياض:
«مدَّ جسرا..
يتراءى الوقتَ أعوامًا..
ليالْ..
كم تبقّى؟
يا له هذا السؤالْ..
مثل مَنْ يثقبُ صدرا..
أتُرى الباقي سويعاتٍ..وشهرا؟
لستُ أدري..
لا، ولا غيري بهِ قد كانَ أدرى»..
****
المؤلم هنا في نص حسين إن «الثغرَ» ـ وهو المعادلُ الموضوعيُّ للحياة حيث أنقذ شهرزادَ من سيفِ شهريار في تلك الأسطورة الشهيرة ـ كونه يحملُ دلالاتٍ فاتنةً تحتفي بالحياة، بالكلام الرقيق والهمس الجميل والقصائد الناعمة وبوح العاشقين وما تفضي به القبل..أقولُ: المؤلم إن هذا الثغر يستحيل قبرًا بل يستحيل إعلانًا عن أنّ كل سنوات العمر التي «عاشها» الشاعرُ لم تكن «عيشًا»، لم تكن «حياةً»، إنما كان ذلك العمرُ محضَ موت.. قالِبًا التعبير المعتاد «عشتُ عمرًا» إلى «مِتُّ عمرًا».. هكذا:
«مدَّ جسرا..
كيف صار الآن كهفًا؟
كيف صار الثغرُ قبرا؟
لكأنّي مِتُّ عامًا،
وسنينًا،
مِتُّ عُمْرا»..
** وفي قصيدة أخرى يحتضنها هذا الديوان، يخاطب شاعرنا الراحل قرية القصار الجميلة التي أضحت أطلالًا بعد غياب سكانها عنها مؤكدًا بشكل قاطع على أن «العمر رحل» هو أيضًا وليس السكان فقط..هكذا:
رحلَ العمرُ يا قصاري، وقلبي
ـ من حنينٍ ـ يضمُّ عشقًا «قصارَه».
*******
لقد ظلَّ حسين سهيل في سياق نصوص ديوانه «ذاكرة الشفق» مشغوفًا بالحديث عن الرحيل والراحلين، والعبور والعابرين، وكأنه يرسّخُ فكرة أن هذه الدنيا ما هي إلا محطة سفر وأن الآخرة دارُ راحةٍ أبدية مؤكدًا أنه مهما طال بنا المكثُ فثمة سفرٌ وارتحالٌ وثمة غيابٌ طويلٌ عميق..
قال أبو رياض في كلام موجز مؤثر:
«أجلْ أيها العابرون / استريحوا..
هنا نبتةُ الريح ِ،
وجهُ الخرافةِ،
فحمُ اليبابْ..
هنا التيهُ شيءٌ يُسمّى الغيابْ
وشيءٌ يُسمّى العذابْ»..
** وفي مقاطع أخرى يتناول أبو رياض موت الأمكنة، وسيادة الوحشة، وانطفاء الشوارع، وموت الصوت البشري، وهيمنة السكون والصمت الذي يعوي، وغياب الناس، وسطوة الخوف، وبقايا بقايا الوجود، وصراخ العدم، وحضور الأشباح، وبقايا الظلال..وأن لا أحد.. لا أحد..سوى رائحة ترابٍ دقيقٍ هو رائحة تراب القبر ولا ريب..كل ذلك نستلهمه في هذه المقاطع الشعرية العميقة التي زلزلتني:
«تحسستُ وجهي / وجلدي / مكاني.
بقايا من الظلِّ لما تزلْ..
بقايا أواني..
ورائحةٌ لونها كالترابِ الدقيقِ
وصمتٌ له وحشةُ الراحلينَ
على»دكّةٍ«في سباتِ الزمانِ»..
وفي مقطع آخر يقول:
«يا وحشة الديارِ للديارْ
«مطفأةٌ هي الشوارعُ الكثارْ»
يعوي بليلها السكونُ،
يذبلُ النهارْ
الصوتُ ماتَ من هنا
يلتّفُ في الضحى انصهارْ».
ويقولُ أيضا في مقطع ثالث:
«ورحتُ أسائلُ من غادروا دارَهم
أسائلُ جدرانهم
والمكانَ المخيف
وما من أحدْ»
ويضيفُ مدركًا أنه يسيرُ وحيدًا إلى حتفِهِ، إلى حيث لا أحد..سوى حضور الظلام المخيف الكثيف والسبات الأبدي، هكذا:
«وقد جئتُ وحدي
لكيما أراني
وما من أحد
وما من أحد
غير هذا الظلامْ»..
** وأخيرًا أقول: كما تناول شاعرنا موت المكان، تناول أيضًا الموت في الزمان، حيث تتجمد حركة الزمن، وتتوقف عقاربُ الساعة عن اللهاث، ويسود الموت وذبول الحياة..هكذا في مقطع من أجمل المقاطع وأكثرها شاعريةً وشجنًا:
مدَّ جسرا..
دقّتِ الساعةُ فجرا
مرّةً..أو مرتينْ
لم يعُدْ يسمعُها..
صارتِ الساعةُ
ص خ ر ا....
* شاعر وصحافي سعودي
